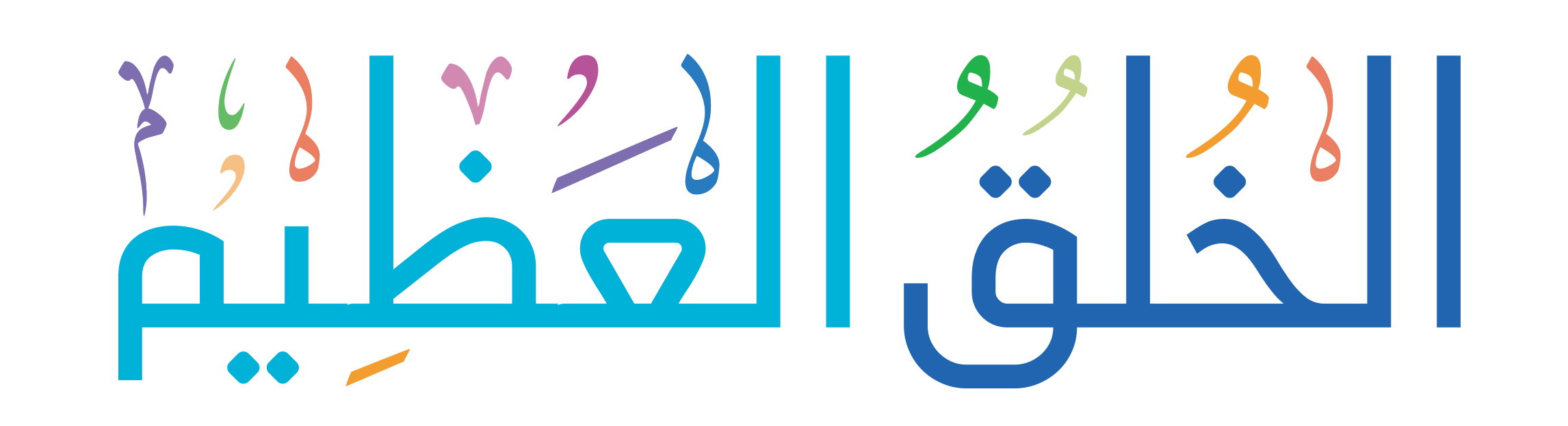القلوب أوعية تحتاج جهداً لإفراغها من الأمراض والآفات وملئها بما يزكيها من الصالحات
للتخلية دور كبير في تصحيح العقيدة وإصلاح النفس وتحسين الأخلاق
من أراد أن يكون ذا عقيدة سليمة فليبتعد عن الأفكار المنحرفة والاعتقادات الباطلة
المؤمن القوي يحرص دائماً على سلامة قلبه وتطهيره ونظافته من المفسدات والآفات
من زكَّى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه
إنها المحطة المهمة التي يحتاجها كل إنسان، ليعيش سعيداً مرتاح البال في دنياه، ويحيا ويفوز الفوز العظيم في أخراه، تبدأ رحلة الوصول إليها بوضع الأثقال من الذنوب، والتخفف الكامل منها، ثم التزود بكل ما يصلح من الأعمال المناسبة في طريق الرحلة الطويل.
هي إذاً محطة تخلية وتنقية للظاهر والباطن من أدران الآثام وأقذار الخطايا، كما أنها تنظيف وتطهير للقلوب والعقول من كل ما يدنسها ويعطل عملها ويمنع وصول الخير إليها، ومن ثَمَّ تكون التحلية بكل جميل وصالح، أما الثمرة المرجوة من ذلك كله فهي عظيمة؛ إنها تزكية النفس.
إن النفس البشرية تميل إلى الدعة والفتور، والكسل والتسويف، حيث تغريها الشهوات، وتتأثر بما يحيط بها من زينة الحياة الدنيا، وقد قال الله تعالى في كتابه: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ) (آل عمران: 14).
ولمَّا كانت النفوس والقلوب عرضة للتغير وعدم الثبات وَورود الفتن عليها؛ فقد منحنا الله فرصة للتوبة والاستغفار، والأوبة والندم، والتجديد والإصلاح، كما دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التناصح فيما بيننا، فقال: «إن الدين النصيحة» (صحيح النسائي)، ذلك لأن الإنسان قد يغفل وينسى ويضعف؛ فيحتاج للتذكرة من حين لآخر حتى يرتقي بنفسه وينقيها من آفات العصيان؛ لتتحول من نفس أمارة بالسوء، إلى نفس لوامة على التقصير، ثم تكون نفساً مطمئنة مطيعة لله منقادة لأوامره، وذلك بفضل الله أولاً، ثم بالمجاهدة والتخلية التي تتبعها التحلية.
التخلية قبل التحلية
التخلية طهارة للقلب وتزكية للنفس، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) (التوبة: 103)، قال ابن عاشور: قوله «تطهرهم» إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات، وقوله «تزكيهم» إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات، ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية.
فالتخلية تكون قبل التحلية، فإن الوعاء الذي يملؤه صاحبه بما يختار ويشاء لا يستطيع أن يضع فيه شيئاً إذا كان مملوءاً بمادة أخرى، ومن هنا كان عليه أولاً أن يفرغه مما فيه ثم ينظفه مما علق به من تلك المادة، وبعد ذلك يصب فيه ما يريد، وهكذا القلوب والنفوس هي أوعية تحتاج منا عملاً وجهداً حتى نفرغ ما فيها من أمراض وآفات تتفاوت من شخص لآخر، ثم نملؤها بما يزكيها ويرفعها من الصالحات، وقد قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى {14} وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى {15}) (الأعلى)، قال ابن عاشور: معنى «تزكى»: عالج أن يكون زكياً؛ أي بذل استطاعته في تطهير نفسه وتزكيتها، وقُدم التزكّي على ذكر الله والصلاةِ لأنه أصل العمل بذلك كله، فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فعُلمت منافعها وأكثرت من الإِقبال عليها.
دور التخلية والتحلية في تربية النفس وتزكيتها:
والحاجة إلى التخلية في حياتنا مطلوبة ومهمة، فما من عمل نقوم به إلا ويحتاج لتلك التخلية حتى يكون خالصاً وكاملاً، وقد قال الله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا {9}) (الشمس)؛ أي: «طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح» (تفسير السعدي)، وقال الحسن: «معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل» (تفسير البغوي).
وللتخلية دور كبير في تصحيح العقيدة، وإصلاح النفس، وتحسين الأخلاق، ففي قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا {9}) قال السعدي: من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، وقال ابن كثير: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم.
إن على كل من أراد أن يطيع الله عز وجل أن يتخلى أولاً عن المعصية ويتوب منها ويستبدل الطاعة بها، وينزع حبها من قلبه ويستبدله بكراهيتها وبغضها، ومن حرص على تخلية قلبه من الشرك سارع إلى البعد عنه وعن أسبابه، وآمن بالله وحده رباً وخالقاً ومعبوداً؛ فإن دعا فلن يدعو سواه، وإن رغب ورهب فمنه وحده، وإن مسه الضر فله يجأر، وإليه يلجأ، فقد خلى قلبه مما سواه سبحانه وتعالى.
ومن أراد أن يكون ذا عقيدة سليمة فليبتعد عن الأفكار المنحرفة، والاعتقادات الباطلة، والبدع المضلة وليتبع القرآن والسُّنة.
ومن حرص على أن يكون ذا خلق عظيم فإنه يعمل عملية جرد وتنقية لأخلاقه خُلقاً خُلقاً، وتخلية السيئ منها وتنحيته عنها واستبداله بالحسن، فإن كان فظاً غليظاً ترك ذلك إلى الرحمة واللين، وإن كان يخوض في أعراض الناس استبدل بذلك الذب عنهم وذكر محاسنهم، وإن كان يجلس مجالس الغيبة والنميمة وصحبة السوء؛ هجرها لمجالس الذكر والعبادة مع عباد الرحمن، وإن كان يعمل عملاً يفسد به في الأرض تحول منه إلى الإصلاح فيها وعمارتها.
وهكذا فإنه يقوم بالتخلية إلى التحلية، فمن الجهل إلى العلم، ومن الغضب إلى الحلم، ومن البخل إلى الجود، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الطمع إلى القناعة، ومن الأثرة إلى الإيثار، ومن العقوق إلى البر، ومن المعصية إلى الطاعة في أمره كله.
ولا يكون المحل من قلبه ونفسه موضع قبول لصالح الأعمال والأخلاق إلا بعد تخليته مما يشغله ويبعده عن ذلك، فإن فعل طهرت نفسه وزكت وصار في درب المفلحين، كما قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى {14} وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى {15})، قال ابن عاشور: قد رتبت هذه الخصال الثلاث على الآية على ترتيب تولدها؛ فأصلها إزالة الخباثة النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهو المشار إليه بقوله: «تزكى»، ثم استحضارُ معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار بقوله: «وذكر اسم ربه»، ثم الإقبال على طاعته وعبادته وهو المشار إليه بقوله: «فصلى»، والصلاةُ تشير إلى العبادة.
أين قلبك من التخلية؟
أين أنت أيها المؤمن من تخلية قلبك وتحليته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تُعرَضُ الفتنُ علَى القلوبِ كالحصيرِ عوداً عوداً فأيُّ قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَ فيهِ نُكتةٌ سَوداءُ وأيُّ قلبٍ أنكرَها نُكِتَ فيهِ نُكتةٌ بَيضاءُ حتَّى تصيرَ علَى قلبَينِ علَى أبيضَ مِثلِ الصَّفا فلا تضرُّهُ فتنةٌ ما دامتِ السَّماواتُ والأرضُ، والآخرُ أسوَدُ مُرباداً كالكوزِ مُجَخِّياً، لا يعرِفُ معروفاً ولا ينكرُ مُنكراً إلَّا ما أُشرِبَ مِن هواه» (رواه مسلم)، فوصف الحديث قلبين: الأول كالصَّفا وهو الحجر الأملس، يشبهه في نقائه وبياضه ونظافته ونوره وبهائه، والآخرُ أسوَدُ مُربادّاً؛ أي كلون الرماد، وهو كالكوزِ مُجَخِّياً؛ أي مائلاً منكوساً.
ألا إن المؤمن القوي يحرص دائماً على سلامة قلبه وتطهيره ونظافته من المفسدات والآفات ما ظهر منها وما بطن؛ حتى يلقى الله بقلب سليم (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ {88} إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ {89}) (الشعراء)، فحين تعرض عليه الشهوات وتتزين فإنه لا يأخذ منها إلا القدر المناسب الذي لا يفسد قلبه، وإذا ما اعترضته الشبهات والشكوك فإنه يطردها بعيداً عنه حتى يثبت على دين الله.
إنه يبدأ رحلته إلى التخلية بالتوبة النصوح وتخلية القلب مما فيه من أمراض، وتحليته بما يحييه الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى: (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) (الأحزاب: 4)، وقد قال القرطبي عن القلب: «هو محل الخطرات والوساوس ومكان الكفر والإيمان، وموضع الإصرار والإنابة، ومجرى الانزعاج والطمأنينة.. وأنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان، والهدى والضلال، والإنابة والإصرار».
كما أن عليك أن تطلب العون من الله في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله ويطلب منه أن يطهر نفسه ويزكيها فيقول: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها» (رواه مسلم)، فزكى الله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله أطهر القلوب، وأرسله للعالمين ليزكيهم ويطهر قلوبهم، قال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ {164}) (آل عمران).
قـال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «فإن تزكية النفوس مُسَلَّم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها، وجعلها على أيديهم دعوة وتعليماً وبياناً وإرشاداً.. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم، وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة، التي لم يجئ بها الرسل؛ فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم، وعلى أيديهم، وبمحض الانقياد والتسليم لهم».
ألا إن تزكية النفس هي همّ كل مؤمن ومطلب كل مخلص، وإنها لا تكون دون محاسبة النفس بصدق وتخليتها ثم القيام بتحليتها.